
اصدر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية دراسة حديثة حول العنف .وقد كشفت عن ارقام مفزعة.
تقول الدراسة : »اكتسحت ظاهرة العنف الحضري تقريبا جميع المجالات في بلادنا، والمتفحّص لجميع وسائل الإعلام (مرئى/جرائد/صفحات التواصل الاجتماعي…) يلاحظ انتشار هذه الظاهرة سواء في الأنشطة الرياضية، في المدارس، المعاهد، الجامعات، في التحركات الاجتماعية والسياسة وحتى داخل الأسرة وفي الأحياء السكنية (سواء كانت شعبية أو مترفهة).
والملاحظ أنّ العنف بلغ درجة يتعذر اعتباره تضخيم إعلامي بل أصبح واقعا اجتماعيا يستوجب تدخل جميع الأطراف المتداخلة داخل الدولة والمجتمع لتفسير الظاهرة وفهمها ومعالجة أسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
إنّ استفحال ظاهرة العنف داخل الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، مؤسسات الدولة، الملاعب الرياضية، الطريق العام… رغم وعي الجميع بخطورة ذلك على المجتمع والسلم الاجتماعي يستدعى تدخل المختصين وعلماء الاجتماع والقانون لكشف الدوافع الخفية لانتشارها وزيادة حدتها والعوامل المغذية لها. وإيجاد الحلول اللازمة والبديلة لمجتمع متصالح مع نفسه ومع الآخر.
تعريف العنف: العنف هو كلّ فعل ينتهك القانون المنظّم للعلاقات الاجتماعية، ويتعارض مع القيم والعادات والأعراف التي يسطرها المجتمع وينتظم وفقها، ويكون من نتائجه إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالأفراد والممتلكات العامّة منها والخاصّة.
ويمكن أن يكون العنف مشروع وهو الذي تحتكره الدولة لبسط سلطة القانون وعنف غير مشروع وهو العنف الذي يمارس ضدّ الأشخاص وضد المؤسسات العامة والخاصّة، ضد الأفكار… وعموما الذي يمثل خطرا على السلم الاجتماعي.
ويعتبر العنف إشكالا مركبا متعدد المسببات والتمظهرات، فعلى المستوى النفسي هو عجز الأنا عن تكييف النزاعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمه ومثله ومعاييره إضافة إلى عجز الذات عن القيام بعملية التسامي والإعلاء ويقابله ضعف الأنا الأعلى الذي يطلق الميول الغريزية فتلتمس الإشباع بواسطة العنف كما تزداد العدوانية مع ازدياد الكبت اضافة إلى الصراعات الداخلية والمشاكل الانفعالية والشعور بالاحباط والخوف وعدم الأمان والشعور بالنقص.
أمّا من الناحية الإجتماعية فانّ تأثير التنشئة والبيئة الاجتماعية حين يجد الطفل العنف اللفظي أو الجسدي في طريقة التعامل سواء داخل الأسرة أو في المحيط سبب من أسباب العنف، بالإضافة إلى اقرار ضعف التفكير بالقوة الجسدية وبالمفهوم الخاطئ للرجولة، كما يعتبر العنف من هذه الناحية ردة فعل تجاه التهميش الاجتماعي وغياب الحوار داخل الأسرة، المكتب، المعهد، الجامعة ومراكز العمل والمجتمع.
إنّ تنامي ظاهرة العنف في بلادنا في الفترة الأخيرة وفي كل الأماكن، (مدارس، معاهد، مستشفيات، مؤسسات حكومية وخاصة، الأسرة، الطريق العام، وسائل النقل، الملاعب الرياضية…) استوجبت القيام بدراسة هذه الظاهرة والبحث في أسبابها ودوافعها، الاطلاع على الاحصائيات المسجلة والعمل على تطبيق التوصيات المنبثقة عن جلسة عمل مغلقة بمقر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بحضور مختلف المصالح الأمنية المختصة والمصالح الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني.
رغم تعدد مظاهر العنف داخل المجتمع، إلاّ أنّنا سنقتصر على دراسة الظاهرة من حيث الاحصائيات على المستوى الوطني وعلى العنف في المؤسسات التربوية.
- تنامي ظاهرة العنف في مختلف مؤسسات الدولة وفي الطريق العام:
- ارتفاع ظاهرة العنف على المستوى الوطني:
شغلت ظاهرة العنف خاصة بعد أحداث 14 جانفي الرأي العام فلا يمرّ يوم دون قراءة خبر عن العنف أو عن جريمة تهز الرّأي العام المجتمع التونسي في حدود سنة 2010 ولمدّة 05 سنوات (بداية من 2006) تمّ تسجيل حوالي 180 ألف قضية على مستوى وطني دون احتساب عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضّها سواء داخل العائلة أو عن طريق إجراء تداخل لدى السلطة الأمنية، في حين وإلى حدود 2017 تمّ تسجيل أكثر من 200 ألف قضية على مستوى وطني دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
وتختلف نسب العنف من الوسط الحضرى إلى الوسط الريفي فبالنسبة للوسط الحضري تمّ تسجيل حوالي 110 ألف قضية في حين تمّ تسجيل حوالي 70 ألف قضية في الوسط الريفي وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 وخلال 06 سنوات بداية من 2011 إلى حدود 2017 تمّ تسجيل حوالي 135 ألف قضية في الوسط الحضري في حين تمّ تسجيل حوالي 80 ألف قضية في الوسط الريفي.
ولا تقتصر احصائيات العنف على هذه الأرقام لأنّ جرائم العنف يمكن أن تقترن بجرائم أخرى، كالسرقة، القتل، والسلب وهو ما يرفع في معدّل ارتكاب هذه الجرائم بنسب مفزعة فالمجموع العام مثلا لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة عنه من 2006 إلى 2010 بلغ أكثر من 500 ألف قضية أي أنّ قضايا العنف لوحدها تمثل حوالي 20% من العدد الجملي للقضايا.
في حين تجاوز المجموع العام من 2011 إلى 2017 إلى أكثر من 600 ألف قضية مسجلة أي بمعدل 25% من العدد الجملي للقضايا وهو ما يرفع مؤشر تزايد العنف ببلادنا.
وإلى جانب العنف ارتفعت قضايا القتل مقارنة بين الفترة المتراوحة ( من 2006 إلى 2010) والتي بلغت حوالي 1000 قضية في حين تجاوزت هذه النسبة 1550 من 2011 إلى حدود 2016 ويمكن أن ترتفع إلى 1700 في موفى 2017.
وفي قراءة للمستوى التعليمي للأشخاص الذين تورطوا في قضايا العنف خلال 10 سنوات من 2007 إلى 2017 نجد أنّ 66% مستواهم تعليم أساسي في حين 34% مستوى ثانوي وجامعي.
أمّا بالنسبة لمعدل الأعمار خلال 10 سنوات من 2007 إلى حدود 2017 لوحظ أنّ 95 % أعمارهم أكثر من 18 سنة و5 % أقل من 18 سنة.
إنّ ارتفاع مؤشّرات العنف الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي يعود إلى عدّة اعتبارات وهي:
- الكثافة السكانية في بعض الأحياء (دوار هيشر، حي التضامن، الكرم، سيدي حسين السيجومي…) والخليط المجتمعي وبقاء فكرة الجهويات لدى البعض.
- التفكّك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة والهشاشة الأسرية في بعض الأحيان.
- تراجع دور المدرسة والمعلم
- الضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والبطالة
- ارتفاع منسوب العنف الثوري والاحتجاجات بعد أحداث 14 جانفي.
- تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية:
لم تكن المؤسسات التربوية بمنأى عن ظاهرة العنف حيث تمّ تسجيل حالات عنف لفظي وجسدي بمؤسساتنا التربوية وصلت إلى حدود غير معقولة وغير مبررة وفي ما يلي حوصلة لعدد حالات العنف ونسبها المسجلة بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي خلال 03 سنوات من 2012 إلى حدود 2015.
خلال سنة 2017 تواصل ارتفاع عدد حالات العنف داخل المؤسسات التربوية سواء تلك الصادرة عن التلامذة أو الأساتذة أو من الإداريين وبقية الأسرة التربوية حيث تمّ في الغرض تسجيل النسب التالية:
|
عدد حالات العنف المادي الصادر عن |
عدد حالات العنف اللفضي الصادر عن |
||||
|
تلميذ |
أستاذ |
بقية أسرة تربوية |
تلميذ |
أستاذ |
بقية أسرة تربوية |
|
14792 |
7392 |
4812 |
5552 |
920 |
815 |
|
54.8% |
27.4% |
17.8 % |
76.2 % |
12.63 % |
11.17 % |
وما يلاحظ في حالات العنف أنّه تمّ تسجيل 77 % من حالات العنف بالمجال القروي ممّا يوحى بأنّ العنف المدرسي حالة حضرية بامتياز وأنّ حالات العنف المدرسي بالمدن أكثر من حيث العدد وذلك لدواعي مرتبطة بالبيئة الاجتماعية وبمحدّدات أخرى كالبنية الديمغرافية ودرجة كثافتها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية. هذا وتصدّرت تونس الكبرى أعلى الترتيب من حيث حالات العنف المسجلة وصلت إلى 14 % وتلتها جهة سوسة بنسبة 11 % فجهة صفاقس بنسبة 10 % مع الاشارة أنّ 4/3 التلاميذ المتوّرطين في السلوكات المنحرفة هم من الراسبين وثلثيهم 3/2 ممّن تكون نتائجهم خلال العام الدراسي ضعيفة.
وبالرجوع إلى الأسباب المؤدّية للعنف المدرسي هناك أسباب تعود إلى:
- الأسرة من خلال:
- تقلّص دور الأسرة التأطيري في ظلّ عمل الأبوين والالتجاء إلى المحاضن
- التفكّك الأسري النّاجم عن الطلاق
- عدم اشباع الأسرة لحاجيات أبناءها نتيجة تدني مستواها الإقتصادي
- المجتمع وذلك نتيجة:
- الفقر والحرمان في بعض الجهات والأحياء
- جذور المجتمع المبني على السلطة الأبويّة ما زالت مسيطرة، فنرى على سبيل المثال أنّ استخدام العنف من قبل الأب أو المدرس هو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير الإجتماعية السليمة وحسب النظرية النفسية الإجتماعية فانّ الانسان يكون عنيفا عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكا ممكنا مسموحا ومتفقا عليه
- النظرة التقليدية القائمة على تمجيد التلميذ النّاجح والتقليل من شأن التلميذ الفاشل دراسيا
- عدم وجود سياسات منظمة لأوقات الفراغ وطرح الأنشطة الترفيهية البديلة
- الثقافة عبر:
- عزوف الشباب عن دور الثقافة والشباب ونوادي الأطفال لغياب البرمجة الثرية والتجهيزات العصرية
- المدرسة بسبب:
- قلّة التنشيط الثقافي والرياضي
- عدم توفّر الأنشطة المتعدّدة والتي تشبع مختلف الميولات والهوايات
- اعتماد بعض المواد على الالقاء وغياب الديناميكية والتي يلجأ فيها التلميذ إلى التشويش
- زوال القدوة التعليمية: المتغيرات الاقتصادية التي يواجهها كلّ من الطّالب والمدرّس وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي أفقدت هيبته.
التوصيات:
- المصالح الأمنية:
- التفكير في اتخاذ اجراءات عاجلة من خلال فرض احترام القانون والتراتيب والمناشير وعدم الخذوع للابتزاز وتطبيقها حينيا في جميع الوزارات.
- تفعيل الدور الأساسي لوزارة التربية، وتنقية محيط المؤسسات التربوية والعمل على توسيع الفضاء البيداغوجي واحترامه.
- تجهيز الفضاءات العمومية تقنيا ( شبكة الكاميرا)
- حماية العائلة من خلال النصوص القانونية
- تفعيل السياسة الجنائية في مقاومة العنف من خلال التطبيق الصارم للقانون
- تفعيل دور “رئيس الوحدة المنية” للأمن العمومي (حرس وشرطة وطنية) خاصّة في المجال العلائقي للحفاظ على السلم الاجتماعي وإلزامه على العمل على فض الاشكاليات مع إقتراح تربصات عمل في المجال الاجتماعي ضمن حلقات التكوين.
- تغيير الفضاء التربوي ليصبح التلميذ هو من يساهم في الدرس ( المقصود ترتيب الطاولات)
- التأكيد على العمل ضمن مجموعات لتحقيق أهداف مضمونة الوصول وتحسيس الفرد بمسؤوليته ضمن المجموعة وخلق روح المسؤولية
- مراجعة الدروس البيداغوجية في النظام التعليمي وإعادة مكانة المربّي كمثال يقتدي به من كل النواحي( الانضباط، المظهر الخارجي)
- ضرورة الدفع والتحفيز نحو أداء الواجب الوطني وانتهاج سياسة اعلامية للحدّ من ظاهرة العنف.
- توصيات الأطراف المتداخلة في المجال الإجتماعي:
- ادراج برنامج الوقاية من العنف ضمن البرامج الوطنية ودعم الطب المدرسي والجامعي والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر
- ارجاع نوادي الصحة والنهوض بالصحة النفسية، وتفعيل استراتيجية خاصة بها وانشاء هيكل صلب وزارة الصحة خاص بظاهرة العنف سواء داخل الطريق العام أو المسلط على أعوان وإطارات ومؤسسات وزارة الصحة.
- تنظيم حوار مجتمعي بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة والعمل على استراتيجية وطنية لمكافحة العنف.
- تعزيز الدور الوقائي من خلال تطوير المشهد الثقافي (دور ثقافة، مسارح، سينما…) وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية
- تعزيز الخطة الوطنية للدفاع الاجتماعي وتعزيز الاحاطة بالفئات الاجتماعية ذات السلوكيات الخصوصية والعمل على توحيد قاعدة بيانات حول ظاهرة العنف والإحصائيات في الغرض.
- برمجة زيارات ميدانية للمبيتات والأحياء الجامعية لتقديم الإحاطة النفسية للطالب لتجنيبه السلوكات المؤدية للعنف وكذالك الإحاطة بضحايا العنف.
- العمل على مزيد انتداب والتعاقد مع أخصائين نفسانيين
- العمل على تلافي الاكتظاظ بالمطاعم الجامعية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والبحث.
- التكثيفمنالرحلاتالترفيهيةوتفعيلالرياضةغيرالتنافسية
- معالجة الزمن المدرسي لتوفير مساحات زمنية لتعاطي الأنشطة الثقافية والرياضية
- تفعيل دور الأندية والتظاهرات الثقافية بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية والحرص على دعمها بالتجهيزات والاعتمادات اللازمة لإنجاح مختلف المشاريع الثقافية
- التنسيق مع وزارة النقل لتمكين الطّالب من خدمات النقل الجامعي من وإلى المؤسسات الجامعية في ظروف مناسبة ومريحة
- التنسيق مع المصالح الأمنية قصد حماية الطلبة المقيمين من التعرّض إلى العديد من الانتهاكات من قبل بعض المنحرفين بالأحياء المجاورة للمبيتات الجامعية خاصة بالأحياء الشعبية
- دعوة كل الطلبة إلى الإبلاغ عن الحالات المرضية التي تهدد بالعنف حتى يتم التدخل العلاجي الوقائي في الوقت المناسب
- مراجعة البرنامج الأكاديمي للتعليم العالي في اتجاه وضع مواد اجبارية تعني بحقوق الانسان والسلوك الحضاري والمواطنة
- التكثيف من المراقبة الأمنية بمختلف وسائل النقل
- تخصيص اعتمادات للتحسيس والإعلام لمحاصرة ومواجهة العنف خاصّة من خلال الومضات الاشهارية التي تتخلّلّ المباريات الرياضية الوطنية والبرامج ذات الاقبال المكثّف.
- وضعاستراتيجيةلاتقومبالأساسعلىمعالجاتعقابيةوردعيةبلمعالجيةوقائيةوعلاجيةثقافيةوتربويةوربطآفةالعنفبآفةالبطالة
- تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية للمدارس والمعاهد ومزيد الاعتناء بتأهيل المتدخلين في المؤسسة التربوية الى جانب الارتقاء بخدمات الاستكشاف وتعميقها والعمل على استباق وقوعحالاتالعنفوتركيزثقافةتقومعلىمبدأاللاّعنففضلاعنارساءمنظومةاعلاميةفاعلةوإجراءتقييماتوظيفيةلأداءالمؤسساتالتربويةفيهذاالمجال
- تفعيل ادوار المجالس البيداغوجية ومجلس المؤسّسة الى جانب ارساء فضاءات لخلايا المرافقة والإصغاء والإرشاد بالمدارس الاعداديّة والمعاهد
- ارساء ميكانيزمات التنسيق الناجعة بين المندوبيات الجهوية للتربية والمصالح المركزية للوزارة ومع باقي المتدخلين من مصالح ادارية ووزارات ذات علاقة كوزارة الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات والمنظمات.
- توجيه انشطة النوادي الثقافية والرياضية والفنية في اتجاه ترسيخ ثقافة اللاّعنف مع الحوار فضلا عن تنظيم مسابقات تسند خلالها جوائز الى المدارس التي لم تسجّل فيها حالات عنف ومساهمة كل مدرسة عن طريق تلاميذها في صياغة ميثاق داخلي شعاره «مدرسة بلا عنف» يرسخ قيم التسامح والاحترام المتبادل
- مزيد تشريك الأولياء في متابعة ومراقبة أبناءهم وتقاسم المسؤوليّة التربويّة بين المؤسّسة التربويّة والأسرة.

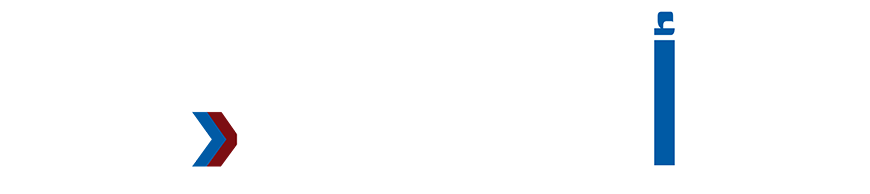
شارك رأيك