تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية لدينا من بلدان جنوب الصحراء هروبًا من انعدام الأمن وسوء الأوضاع الاقتصادية، وبحثًا عن ظروف حياة أفضل. ولّد هذا الواقع مجموعة من الآراء المتباينة في الشارع التونسي يمكن تسميته اصطلاحا بـ “الرأي العام”. وبعيدًا عن المتاهات والاختلافات التي جرَت فيها أقلام الكثيرين وخاصة الجدل حول موضوع “تونس أرض عبور” أو “موطن استقرار”، ارتأيت الاكتفاء بالوقوف عند “الظاهرة” كقضية رأي عام لها تداعيات وتحدّيات.
العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها
اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.
تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.
دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.
تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.
الهجرة قضيّة رأي عام
اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.
تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.
وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.
كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!
الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.
صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.
الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.
المكافحة مُقاربة مشتركة
تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.
في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.
في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.
تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.
تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.
ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

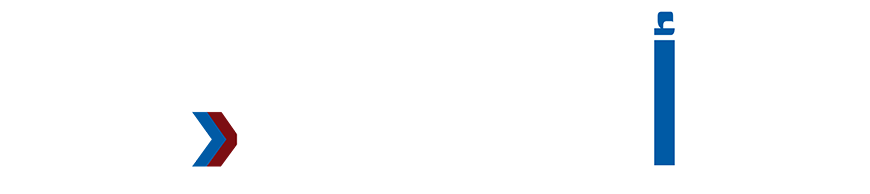

شارك رأيك