يعتبر الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يشكل أحد الأعمدة الأساسية للصادرات التونسية ويعدّ سلعة استراتيجية في الأسواق العالمية، خصوصًا في صناعة الأسمدة. ومع ذلك، لم يكن لهذه الثروة أي انعكاس حقيقي على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة المواطنين، بل تحول إلى مصدر للاستغلال الطبقي، والتبعية الاقتصادية، والكوارث البيئية، وساحة للتلاعب السياسي.
رياض الشرايطي

اليوم، تطرح السلطة الحالية هدفا طموحا يتمثل في رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يبدو في ظاهره محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الحقيقة شعار أجوف يخفي وراءه عجزا بنيويا، و إداريا .
1- أزمة الإنتاج: لماذا يتراجع قطاع الفسفاط؟
التدهور الهيكلي والبنية التحتية المهترئة :
يعتبر الفسفاط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ولكن منذ ثورة 2011، شهد القطاع تراجعا حادا في الإنتاج. فبعد أن كان الإنتاج السنوي يقترب من 8 ملايين طن قبل الثورة، انخفض إلى 3 ملايين طن فقط في 2024، وهو ما يعكس انهيارا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي.
أسباب التدهور الإنتاجي:
تآكل البنية التحتية : لم تتم صيانة أو تحديث تجهيزات المناجم والمصانع منذ سنوات، ما أدى إلى تراجع كفاءة الإنتاج.
-استثمارات غير واضحة المصير: الحكومة خصصت 2688 مليون دينار لتحسين الإنتاج، ولكن لا يوجد أي شفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
نقص الكوادر والتكوين التقني: أدى تراجع التكوين المهني إلى ضعف في تأهيل العمال، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.
كما يقول المفكر الألماني كارل ماركس: “الرأسمالية لا تخلق الثروة إلا بخلقها للفقر معها.”، وهو ما ينطبق تمامًا على قطاع الفسفاط الذي يدرّ المليارات بينما تعاني المناطق المنجمية من الفقر المدقع.
2- الفسفاط والاستغلال العمالي: كيف يُنهب العمال تحت راية “الثروة الوطنية”؟
ظروف عمل غير إنسانية :
يواجه عمال الفسفاط مخاطر صحية كبيرة، إذ يتعرضون يوميًا إلى غازات سامة، وانبعاثات الفوسفات، والأمراض الرئوية المزمنة. كما أن الحوادث القاتلة في المناجم ليست نادرة.
– أبرز مشاكل العمال في قطاع الفسفاط:
– رواتب زهيدة لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع.
– عدم توفر معدات الحماية الكافية، ما يجعلهم عرضة لإصابات خطيرة.
– عدم تعويض العمال المصابين، مما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والمرض دون دعم.
المفكر الفرنسي بيير بورديو قال: “كلما زاد الفقر، زادت حاجة النظام إلى تبريره.”، وهو ما ينطبق على تونس، حيث يتم تحميل العمال مسؤولية تدهور القطاع بينما تنهب الشركات أرباحه.
3 – احتجاجات طالبي الشغل: صرخة شباب المناطق المنجمية
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تصدير الفسفاط كمنتج استراتيجي، تعاني قفصة من معدلات بطالة مرتفعة بشكل كارثي. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات المطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية خاصة في الحوض المنجمي.
لماذا يحتج الشباب في المناطق المنجمية؟
– غياب التشغيل رغم الثروة: رغم أن ولاية قفصة تمثل القلب النابض لصناعة الفسفاط، إلا أنها من أكثر الولايات تضررًا من البطالة، حيث تصل إلى أكثر من 30% في بعض المعتمديات.
– غياب برامج تنموية حقيقية: الدولة لا تستثمر في مشاريع بديلة عن الفسفاط، مما يجعل السكان رهائن لهذا القطاع الوحيد.
– قمع الاحتجاجات بدل الاستجابة للمطالب : بدل أن تسعى الحكومة لحلول جذرية، تلجأ إلى القمع القضائي وإخماد الاحتجاجات بالقوة، ما يعكس غياب أي رؤية تنموية حقيقية.
كما يقول أنطونيو غرامشي: “الدولة الرأسمالية لا تحل المشاكل، بل تديرها لصالح الطبقة الحاكمة.”، وهو بالضبط ما يحدث في تونس، حيث يتم تسيير الأزمات بدلاً من حلها
4- الكارثة البيئية : كيف يحوّل الفسفاط تونس إلى منطقة منكوبة؟
التلوث الجوي والمائي: تعتبر مصانع الفسفاط مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي، حيث تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت، والغبار الفوسفاتي، والمعادن الثقيلة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي في مناطق الإنتاج مثل قفصة.
تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2021 أشار إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في قفصة أعلى بـ 3 مرات من المعدل الوطني بسبب التلوث الناتج عن صناعة الفسفاط.
أما على مستوى المياه، فإن مصانع الفسفاط تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما أدى إلى جفاف بعض المناطق المحيطة بالمناجم. كما أن تصريف نفايات الفسفاط في الأودية والبحيرات يلوث المياه الجوفية، مهددا الصحة العامة.
5- شركة الغراسات : رواتب بلا عمل
إحدى المفارقات العجيبة في ملف الفسفاط هي شركة الغراسات والبيئة التابعة لشركة فسفاط قفصة، التي تم إحداثها كحل ترقيعي لتهدئة الاحتجاجات في المناطق المنجمية. ورغم تعيين آلاف العمال فيها، فإن أغلبهم لا يعملون فعليًا، بل يحصلون على رواتب شهرية دون أداء أي مهام، بل وحتى زيادات منتظمة في الأجور.
لماذا لا يعمل عمال شركة الغراسات؟
– عدم وجود مهام فعلية: الشركة تأسست دون أي رؤية واضحة لدورها الحقيقي.
– غياب المشاريع البيئية: رغم أن الهدف المعلن هو “التشجير والبيئة”، إلا أن الواقع يكشف عن عدم تنفيذ أي مشاريع حقيقية.
– استخدام الشركة كأداة لشراء السلم الاجتماعي: الحكومة توظف الشركة لإسكات احتجاجات الشباب دون تقديم حلول حقيقية للبطالة.
أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد:
– تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة لدفع أجور غير منتجة.
– خلق ذهنية ريعية في المناطق المنجمية، حيث يتم ربط التشغيل بالترضيات السياسية بدل الكفاءة والإنتاجية.
6- الحلول البديلة: كيف يمكن تحويل الفسفاط إلى أداة تنمية حقيقية؟
– وقف تصدير الفسفاط الخام والانتقال إلى التصنيع: يجب الاستثمار في مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.
يمكن لتونس أن تتبع نموذج المغرب، الذي يصنع 80% من إنتاجه، مما يحقق له أرباحًا تفوق 5 أضعاف ما تحققه تونس.
– وضع سياسات بيئية صارمة
– فرض رقابة على انبعاثات المصانع.
-.تطوير حلول مستدامة لاستهلاك المياه.
– تشديد العقوبات على الشركات التي تلوث البيئة.
7 – كيف نحرر قطاع الفسفاط من التبعية والتدمير؟
لا يمكن الحديث عن أزمة الفسفاط في تونس دون تقديم تصورات جذرية بديلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، وحماية البيئة. فالحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية تنموية مستدامة، تضع حدًا للاستغلال الطبقي وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة.
– تأميم القطاع وإدارته بمنطق الاقتصاد الوطني لا الربح الرأسمالي.
– انهاء استنزاف الفسفاط لصالح السوق العالمية: بدلاً من تصدير الفسفاط الخام إلى الشركات متعددة الجنسيات، يجب تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.
كما قال المفكر اليساري سمير أمين: “لا يمكن تحقيق التنمية دون قطيعة مع التبعية للأسواق الرأسمالية.”
8- تطوير مشاريع اقتصادية بديلة في المناطق المنجمية:
الاعتماد الكلي على الفسفاط أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية في مناطق مثل قفصة، المتلوي، وأم العرائس، لذا من الضروري:
– اطلاق مشاريع فلاحية وصناعية مستدامة:
– إنشاء مصانع تحويلية للفسفاط داخل تونس بدل تصديره خاما.
– استثمار الأرباح في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المعالجة، مما يخلق فرص عمل جديدة.
– دعم الاقتصاد التضامني عبر تمويل تعاونيات فلاحية وصناعية يديرها العمال أنفسهم.
تجربة بوليفيا في تأميم مواردها الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية يمكن أن تكون نموذجًا لتونس.
9- حلّ أزمة شركة الغراسات عبر مشاريع بيئية حقيقية:
بدل أن تكون شركة الغراسات مجرد آلية لشراء السلم الاجتماعي، يجب:
-.اعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة بيئية حقيقية تتولى إعادة تشجير المناطق المتضررة من التلوث.
-.الزام شركة فسفاط قفصة بتعويض الأضرار البيئية، عبر تخصيص جزء من أرباحها لإصلاح التربة، ومعالجة المياه، وزراعة الأشجار المقاومة للجفاف.
-.توظيف العمال وفق برامج واضحة بدلا من دفع رواتب دون عمل حقيقي.
10 – عدالة اجتماعية في التشغيل وضمانات للعمال:
▪︎.انهاء عقود العمل الهشة وإقرار قانون يضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.
▪︎.ادماج طالبي الشغل في مشاريع تنموية حقيقية بدل توظيفهم في وظائف صورية كما هو الحال في شركة الغراسات.
-.اعادة توزيع الثروة: يجب أن تعود أرباح الفسفاط إلى سكان المناطق المنجمية، عبر بناء مستشفيات ومدارس ومشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب النخب السياسية والبيروقراطية.
كما قال أنطونيو غرامشي: “كل أزمة اقتصادية تحمل في داخلها بذور ثورة اجتماعية.”، وهو ما نراه في احتجاجات أهالي المناطق المنجمية الذين يطالبون بعدالة توزيع الثروة.
11- تبني استراتيجية بيئية مستدامة:
– إلزام الشركات باستخدام تقنيات إنتاج نظيفة، تقلل من انبعاث الغازات السامة وتحد من التلوث المائي.
-.وقف استنزاف الموارد المائية: بدل استخدام المياه العذبة، يجب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه الصناعية وتحلية مياه البحر لتقليل الضغط على الموارد المائية.
-.تحويل الفسفاط إلى قطاع صديق للبيئة، عبر إجبار الشركات على زراعة الأشجار حول المصانع والمناجم، وإلزامها بمعالجة النفايات السامة قبل التخلص منها.
في السويد، تم تحويل الصناعات الثقيلة إلى نموذج بيئي مستدام عبر فرض ضرائب على الشركات الملوِّثة وإجبارها على تمويل مشاريع بيئية، وهو ما يجب تطبيقه في تونس.
12- الخروج من التبعية للأسواق العالمية:
– وقف التصدير العشوائي: بدلا من تصدير الفسفاط الخام بأثمان بخسة، يجب إقامة شراكات عادلة مع دول الجنوب لخلق صناعات تحويلية مشتركة.
– التركيز على السوق الإفريقية والعربية: عبر دعم الإنتاج المحلي وبيع الأسمدة بأسعار منخفضة للدول الإفريقية بدل تصديرها بأسعار السوق العالمية للشركات الأوروبية.
المفكر الاقتصادي ها جون تشانغ أكد أن “الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى أسيرة للفقر.”، وهو ما ينطبق على تونس اليوم.
الخاتمة : خياران لا ثالث لهما – إما اقتصاد شعبي أو استمرار النهب:
أزمة الفسفاط ليست فقط مسألة إنتاج أو تشغيل، بل هي انعكاس للنموذج الاقتصادي الفاشل الذي يخدم الأقلية على حساب الشعب. الحل ليس مجرد رفع الإنتاج، بل إعادة التفكير جذريًا في السياسات الاقتصادية لضمان أن تتحول ثروات البلاد إلى أدوات تحرر وتنمية، وليس إلى وسيلة جديدة للاستغلال.
إما أن نؤمم الفسفاط ونستخدمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، أو نبقى رهائن للتبعية والاستغلال الرأسمالي العالمي.
فاذا استمر النموذج الحالي، ستبقى تونس مستعمرة اقتصادية تستنزف مواردها لصالح الأسواق العالمية دون تحقيق تنمية حقيقية. لا بد من تغيير جذري يقوم على السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وإلا فإن الفسفاط سيظل لعنة بدل أن يكون وسيلة تحرر.
شاعر و ناشط سياسي.

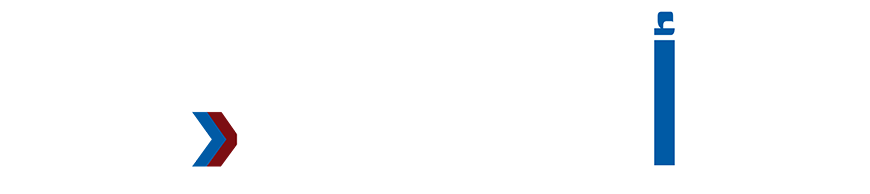

شارك رأيك