تونس اليوم في قلب عملية تحوّل لم تُكتمل معالمها. والمؤمل استخلاص الدروس وعدم تكرار جدل الماضي ولا الارتهان لخطابات المؤامرة، بل صياغة سردية وطنية واثقة، تنطلق من الواقع وتتعلّم من التجارب العالمية. والتاريخ يعلّمنا أن الغضب الشعبي وحده لا يبني الدول، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية وأفكار واضحة.
العقيد محسن بن عيسى

الدولة، كما وصفها ابن خلدون، كائن حيّ يمرّ بمراحل النشوء والقوة ثم الضعف والانحلال. وتونس لم تدخل في خضم ما تعيشه في مرحلة ” شيخوخة خلدونية” بعدُ، وما نشهده ليس سوى عرضٍ من أعراض دورة تاريخية طبيعية. ولا شك أنّ عي الشعب بهذه السّنن يتيح له فرصة لبناء طور جديد عبر إصلاح عميق وشامل.
تقف تونس مرة أخرى على مفترق طرق مصيري، نأمل ألاّ يكون عودة إلى استبدادٍ قديم، ولا استمرار فوضى مهدِّدة، بل نحو مشروع سياسي شامل يقوم على عقد اجتماعي يوازن بين الحرية والنظام، بين الهوية والانفتاح، وبين السلطة والمساءلة.
تونس بعد انتقال 2011
لا يمكن فهم عمق التحول السياسي الذي عاشته تونس دون العودة إلى أحداث 2010-2011. فتح الانتقال الباب أمام الحرية والمشاركة الشعبية، لكنه في المقابل كشف هشاشة المؤسسات وضعف الدولة.
منذ ذلك التاريخ، غابت التوازنات بين السلطات، وتراكمَ النفوذ في جهة دون أخرى مع صراعات داخلية أضعفت القرار العام. ومن المثير للانتباه تغوّل المصالح الخاصة الذي عكسته توجهات حزبية وفردية على حساب المصلحة العامة.
في نفس السياق كشفت بعض الأدبيات انعدام آليات واضحة للحوار والتوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني، مع غياب رؤية مشتركة، وشعورا بفقدان الثقة في الهياكل والمؤسسات، واستقطاب الشعب بين قوى متناقضة.
عدّة تقارير دولية قيّمت أيضا عمل الحكومات المتعاقبة – من صندوق النقد الدولي إلى هيومن رايس ووتش والشفافية الدولية- وقد أجمع أغلبها على محدودية التقدم أمام تحدّيات مستمرّة.
القراءات الخارجية ليست حكمًا نهائيًا، لكنها مرآة تكشف الضعف وتحثّ على الإصلاح. وبغضّ النظر عن مدى دقة ما تتضمّنه، علينا أن نمنح قيمة حقيقية لما يُكتب عن تونس في الدوائر الإقليمية والدولية. صحيح أنها ليست كلّها محايدة، بعضها يخدم مصالح سياسية واقتصادية أو يعكس مواقف حكومات او لوبيات. لكنها تبيّن كيف ينظر الآخرون إلينا، وهذا بحدّ ذاته معلومة قيمة.
التجربة التونسية بعد 2011 تبقى جامعة لعدة تناقضات. من ناحية، هي المثال الوحيد فيما يسمى “الربيع العربي” الذي تجنّب الانهيار الدموي. لقد أسقط الشعب رأس النظام، وفتح فضاءً سياسيًا جديدًا، وذُكر اسم تونس كـ “قصة نجاح”.
ومن جهة أخرى لم يفرز الانتقال قيادة مسؤولة بقدر ما فتح شهية وتهافت على السلطة كغنيمة سائبة. لقد اقتحمت الساحة وجوهٌ امتهنت السياسة بلا رصيد وطني، وأخرى بلا تجربة ولا ثقافة سياسية، تُرشح نفسها لمناصب عليا وكأن الدولة ساحة للتجارب الشخصية.
في السياق، انطلقت موجة استحداث أحزاب هزيلة مع استثناءات قليلة، بعضها بتسميات مستعارة وأخرى بأسماء غريبة، بلا جذور ولا مشروع. أحزاب صُنعت كواجهة لتسويق أشخاص، ومطايا للارتقاء السريع، لا أدوات لإصلاح أو بناء. النتيجة كانت مشهداً سياسياً مرتبكاً، مُشبعاً بالشعارات الفارغة والوجوه الطارئة، حيث طغت المصالح الضيقة على فكرة الدولة، وضاعت الأولويات الكبرى بين الجهل والطموح الأجوف.
لا يخلو هذا المشهد من مبالغات ليست في محلها. وخاصة العودة بنا إلى منطق الزعامات الذي طُوي مع الحركة الوطنية. فالزعامة ليست لقبًا يُمنح، بل مقام له معاييره: رصيد نضالي، وامتداد وطني، وتجربة تاريخية تتجاوز حدود الأشخاص لتخدم الشعب. يمكن تفهّم الحنين إلى صورة ‘الزعيم’ المرتبطة في الذاكرة الوطنية بالشرعية والتضحية، غير أن الاستسهال في إطلاق هذه الصفة اليوم لا يكتفي بفقدان الكلمة لوزنها، بل يحوّلها إلى مجرد صورة إعلامية بعيدة عن موقعها الحقيقي في التاريخ.
تساؤلات وتطلعات 2025
بعد أكثر من أربع سنوات على منعطف 25 جويلية 2021 الذي كان مفصليا في التجربة التونسية، لم تعد الأسئلة تدور حول “ماذا حدث؟” بقدر ما أصبحت تتمحور حول “إلى أين نمضي؟”. التحول السياسي الذي كان يُعتقد أنه مسار نحو الاستقرار، تحوّل إلى شبه أزمة وجودية، تتشابك فيها الخطوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بدأ المسار بتعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة في خطوة وصفت بـ”الاستثنائية”. وتجسيد ديناميكية جديدة على الساحة بالاستفتاء على الدستور في جويلية 2022، ثم تنظيم انتخابات في ديسمبر 2022. وسط هذا المشهد تباينت الآراء حول ما إذا كان الوضع الجديد خفّض التوتر أو زاد الانقسامات.
لا يمكن فصل المسار السياسي عن محيطه الاقتصادي والاجتماعي والأمني. الاقتصاد التونسي يواجه تحديات هيكلية جسيمة، مع توقعات نمو متواضعة من 1.9% الى3%، وارتفاع البطالة إلى 15.7%، بينما تبلغ بطالة حاملي الشهادات العليا 24%. هذه الأرقام تنعكس على الفضاء العام، حيث يتجلى العنف اللفظي والبدني كنتيجة للاحتقان النفسي والاجتماعي.
الدولة ليست مجرد إدارة يومية، بل مشروع سياسي يُبنى عبر شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكم والمجتمع. أيّ مسار نحو المستقبل يجب أن يركّز على:
– إعادة بناء جسور الثقة: عبر حوار وطني شامل يضم كل الأطياف السياسية والنقابية مع الاعتراف النقدي بإخفاقات الماضي و مخاطر الحاضر.
– وضع أولوية الإنقاذ الاقتصادي: ضمن مخطط التنمية 2026-2030 وبرؤية توازن بين الإصلاح الهيكلي الضروري والحماية الاجتماعية.
– حماية الفضاء العام: بضمان الأمن والحريات في آن واحد، واحترام التعددية السياسية والنقابية ودور المجتمع المدني.
التاريخ يعلّمنا أن الغضب الشعبي وحده لا يبني الدول، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية وأفكار واضحة. تجارب البرتغال، اليونان، إسبانيا، الشيلي، جنوب أفريقيا، وألمانيا الشرقية، أظهرت أن الانتقال من الثورة إلى الاستقرار يحتاج عادة من 5 إلى 10 سنوات. أما التجارب العربية فبرزت فيها الفوضى والانقسامات. تدخل عادة الشعوب في ثورات محمّلة بأحلام كبرى: العدل، الكرامة، الحرية، وتحسين نوعية الحياة. كل شعب يضع وزنه على واحدة أكثر من الأخرى. لكن الجوهر دائما هو الرغبة في إقامة نظام عادل.
تونس اليوم في قلب عملية تحوّل لم تُكتمل معالمها. والمؤمل استخلاص الدروس وعدم تكرار جدل الماضي ولا الارتهان لخطابات المؤامرة، بل صياغة سردية وطنية واثقة، تنطلق من الواقع وتتعلّم من التجارب العالمية.

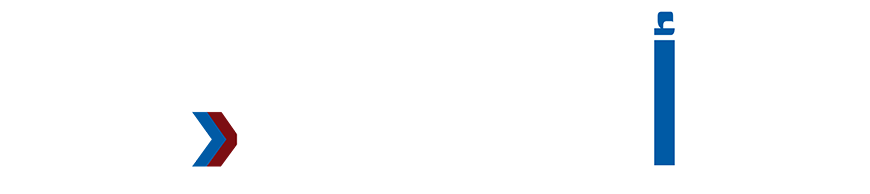

شارك رأيك