لا ينبغي أن يُرفَع شعار “التنوّع” ليُقدَّم وكأنّ تونس بلد فسيفسائي. فالصورة براقة، لكنها خادعة. فهناك فرق جوهري بين تنوّع متجذّر، منغرس في التاريخ وعادات الشعوب، وبين تنوّع مُستورَد، مُفتَعَل، يُستَخدم غالبًا لأغراض أيديولوجية أو سياسية.
خميس الغربي *
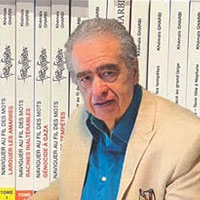
لقد عرفت تونس، شأنها شأن بقية بلدان المتوسط، تلاقحًا بشريًا حقيقيًا. فقد احتضنت قرطاج الفينيقيين والبربر والنوميديين واليونان والرومان، غير أنّ الجميع انصهروا في روح قرطاجية خاصة. ثم جاء الإسلام ليُضيف إلى هذا الإرث لغة عربية وثقافة إسلامية أصبحت مع الزمن القلب النابض للهوية التونسية.
وفي العصور الوسطى، لم تُعتبر الجماعات اليهودية والمسيحية تهديدًا، لأنها اندمجت في نسيج اجتماعي ظلّت العروبة والإسلام قاعدته الصلبة. وكذلك في القرنين التاسع عشر والعشرين، مع قدوم الإيطاليين والمالطيين والفرنسيين إلى تونس وصفاقس وحلق الوادي، نشأت حياة ذات طابع كوزموبوليتي، كوني، لكنها استندت دائمًا إلى هوية تونسية متينة وموحّدة. كان هذا التنوّع موجودًا إلى جانب الهوية الوطنية، وأحيانًا يُثريها، لكنه لم يسعَ يومًا إلى تفتيتها.
لا يُمجَّد الغصن إذا أُنكِر الجذر الذي يحمله
أما اليوم، فثمّة من يُروّج لفكرة “التنوّع المستورَد”، كنموذج جاهز يُفرض من الخارج. غير أنّ تونس ليست لبنان ولا سوريا. فهاتان الدولتان بنيتا على فسيفساء طائفية وعرقية معقّدة: شيعة وسنّة، دروز وعلويون، أرمن وأكراد، آشوريون وآراميون… إلخ. هذه التعدّدية كانت جزءًا من تكوينهما، لكنها أيضًا مصدر وهنٍ ونزاعاتٍ وصراعات لا تنتهي. تونس لم تعرف هذا الواقع قطّ؛ فهي قامت على قاعدة صلبة واحدة: اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، وإرث متوسطي مشترك يشكّل جميعًا إسمنتًا وحدويًا.
إنّ التنوّع الحقيقي ليس قناعًا يُلصَق من الخارج، بل هو ثمرة تحتاج إلى أرض وجذور ووقت لتنضج. ولا يمكن أن يزدهر إلا إذا استند إلى هوية راسخة ومُحترمة. فلا يُمجَّد الغصن إذا أُنكِر الجذر الذي يحمله.
لقد علّمتنا التجارب الحديثة أن الشعوب التي ضحّت بجذورها باسم تنوّعٍ مُصطنع، فقدت جذورها وأغصانها معًا. أمّا الذين تمسّكوا بأصالتهم وانفتحوا في الوقت ذاته على العالم، فقد بنوا مجتمعات قوية، متوازنة ومُثمرة.
تونس ليست فسيفسائية، ولا تعددية، ولا كوزموبوليتية؛ إنها ميراث شعب صاغته القرون في قالب واحد ليكون اليوم شعبًا متجانسًا و موحّدًا.
* كاتب و مترجم.

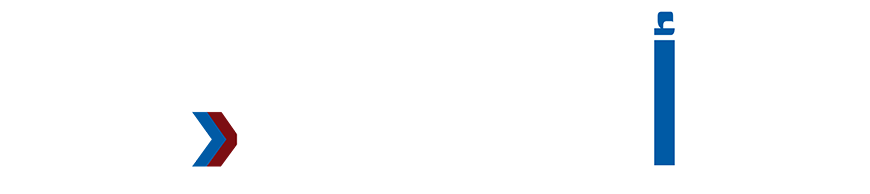

شارك رأيك