
نواصل نشر السيرة الذاتية للشاعر والكاتب التونسي سوف عبيد وهو في هذه الحلقة السابعة يستعيد ذكريات خطواته الأولى في عالم الأدب من خلال الأوقات الممتعة التي يقضيها في المكتبات العمومة الشهيرة في تونس العاصمة و الكتبيات والمقاهي الأدبية في المدينة العتيقة التي تعبق بالحضارة والفن.
بقلم سوف عبيد

في العاشرة من عُمري اِصطحبتُ سِي الحبيب، وكان شابا من أبناء عمّ الوالد، إلى المكتبة العمومية بنهج يوغسلافيا، نهج راضية الحدّاد اليوم، وسِي الحبيب كان على قدر كبير من اللطف والأدب وله بعض الرسائل مع ميخائيل نعيمة فقد اِلتقى به في تونس بمناسبة زيارته ويعتبر تلك الرسائل أثمن ما لديه وينبغي أن أصرح أنه صاحب الفضل الكبير عليّ فقد بذر في مُهجتي محبّة الأدب ومطالعة الكتب وأذكر أن سِي الحبيب عبيد كان يراسل برنامج هواة الأدب بالإذاعة التونسية الذي كان يشرف عليه وقتذاك الشّاعر أحمد اللغماني وقد نال جائزة على إحدى قصصه، الجائزة كانت كتاب أحمد أمين “فيض الخاطر” بأجزائه العشرة ولكن سي الحبيب اِنقطع عن الدّراسة والكتابة مع الأسف فقد أقعده المرض المزمن وفَلّ من عزيمته لكنه ظل متابعا للحركة الأدبية والثقافية ومشّجعا لي دائما وهو الذي أهداني ديوان الشّابي فكان أوّل ديوان شعري في مكتبتي.
في حضرة عالم لا حدود له ولا أبعاد خاصة
عندما دلفتُ إلى تلك المكتبة العمومية الكائنة في قلب تونس العاصمة غمرني شعور البهجة والاِنشراح والوَجل أيضا فلأوّل مرة أرى ذلك العدد الهائل من الكتب على الرفوف في نظام وانسجام وأرى القُرّاء منكبّين جالسين حول المناضد كأنّ على رؤوسهم الطّير فأحسست أنّ هذا المكان هو المقام الأليف الذي وقع هواه في مهجتي من أول نظرة ومن أول خطوة فلم أغادر المكتبة إلا بعد أن أتممت قصة “جزيرة الكنز” من سلسلة “أولادنا” ومازلت إلى اليوم بعد أكثر من نصف قرن أجلس في رحاب تلك المكتبة من حين إلى آخر فينتابني نفس ذلك الشعور الممتع، كيف لا ! وبعض مؤلفاتي تصادفني أحيانا عند أحد الرفوف فأتذكر ذلك الفتى اليافع الذي تمنّى ذات يوم أن يكون له كتاب بين الكتب في تلك المكتبة التي طالع فيها جبران ونعيمة والمنفلوطي وطه حسين وغيرهم والتي قرأ فيها كثيرا من الروايات الفرنسية المنشورة في سلسلة “كتاب الجيب” ومن الكتب التونسية الأولى التي طالعها كتاب “معركة الجلاز” للأديبين محمد المرزوقي و الجيلاني بالحاج يحي الذي صار من أصدقائه وأهداه بعض كتبه التي ساهم بقصيدة قصيرة في أحدها فكم كان سعيدا عندما رأى اِسمه منشورا في كتاب ألّفه أحد الأدباء الذين قرأ لهم وهو فتى.
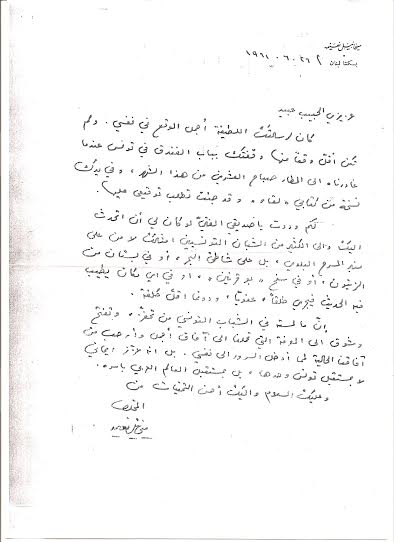
المكتبة الثانية التي أحببتها وأَلِفتُها سنواتٍ طِوالا من عمري هي المكتبة الوطنية بسوق العطارين وقد دخلتها أول مرّة عند دراستي في معهد الصادقية فقد لمحتها في طريقي جيئة وذهابا فتهيّبت الدخول إليها إذ كنت في السنة الأولى من التعليم الثانوي لكني لا أذكر كيف تشجّعت ودخلت فإذا بي أجد نفسي في عالم لا حدود له ولا أبعاد خاصة وأن القواميس والموسوعات ألفيتها في متناول يدي مباشرة على الرفوف فأبحرت فيها وما أمتعه من إبحار !…
مازلت أذكر كيف أنّي وجدت صعوبة كبيرة لدى القراءة في قاموس”لسان العرب” فالطبعة الأصليّة الأولى التي وجدتها وقتذاك كانت الكلمات فيها مرتّبة بحسب أصل حروفها الأخيرة ولم أتفطن إلى ذلك إلا بعد عناء.
ما أروع سنوات العمر التي قضيتها بين رفوفكِ وعلى كراسيك الخشبيّة يا مكتبة العطارين…
تحيّةُ شكر خاصّةٌ إلى عَمْ سالم الذي كان رفيقا بنا وحريصا على إحضار ما نطلبه من الكتب في لمح البصر ونَعجب من ذاكرته الدّقيقة التي تعرف الرّفوف والخزائن كتابا كتابا من دون الرجوع إلى الفهارس… وتحيّةُ شكر أيضا إلى سِي أحمد جليد الذي كان مسؤولا عن الدّوريات من صُحف ومجلات فكان لا يدّخر جُهدا في إحضارها إلينا…
أوّل ما طالعتُ في مكتبة العطارين روايات جُرجي زيدان و كتاب “البخلاء” وكتاب “ألف ليلة وليلة” و”سيرة عنترة” والفضل يعود إلى أستاذي سيّدي البشير العريبي الذي كان يحدثنا عن تلك الكتب فكنت أسعى إليها بلهفة وأقضي العطل في فضاء تلك المكتبة ذات الهندسة العتيقة فهي دافئةٌ شتاءً باردةٌ صيفا ثم قرأت فيها كتاب “الأغاني” وروايات نجيب محفوظ وكتب العقاد في السنة الثانية وتوالت سنوات الشبيبة بين قاعاتها وردهاتها أستنشق شذى الكتب والمخطوطات حتى اِنتقلت المكتبة الوطنية إلى بنايتها الجديدة في شارع 9 أفريل.
كانت المكتبة الوطنية في سوق العطارين مُحاطة بعديد الكُتبيّات الخاصة التي تبيع الكتب العربية القادمة من القاهرة وبيروت، من بين تلك المكتبات مكتبة علي المطوي القريبة من جامع الزيتونة وقد اِشتريت منها كتاب “السدّ” للمسعدي سنة 1967 وأنا لم أتجاوز الخامسة عشرة من عمري واِشتريت منها أيضا دواوين نزار قباني وكتاب “البيان والتبيين” وغيرها من الكتب ومازالت هذه الكتبيّة موجودة (سنة 2016) يقوم على أمرها ابنُه وإلى اليوم ما زلت عندما أمرّ أمامها وأرى الكتب منضّدة أعودُ ذلك الفتى الذي كان يقف طويلا يتصفحّها ويقرأ الكثير من صفحاتها دون أن ينهره صاحبُها رحمه الله.
بالقرب من تلك المكتبة الخاصّة ـ مكتبة السيّد علي الطرابلسي ـ حيث كان يجلس فيها ثلّة من الأدباء والأساتذة تشرفت بمعرفتهم بعد سنوات عديدة من بينهم الجيلاني بن الحاج يحي ومحمد المرزوقي ومحمد اليعلاوي الذي درسني في كلية الآداب.
للمكتبة الوطنية بسوق العطارين ذكريات في وجداني عبقة بما كان فيها من شوق عارم للكتب في سنوات الدراسة والطلب… كنت في كثير من المرات أوّل الداخلين وآخر المُغادرين…
اليومَ… عندما أمرّ أمامها أدرك معنى الوقوف على الأطلال.
تراجعت الحياة الثقافية عامة في أواخر القرن العشرين
لقد اِندثرت أغلب الكتبيات التي كانت محيطة بجامع الزيتونة وتلك التي كانت في شوارع تونس وتحوّلت إلى محلات للأكلات السّريعة أو دكاكين للملابس الجاهزة… فشتّان بين هذا العهد وذاك الزمن… ذاك زمنٌ نشأنا فيه على المطالعة فنهلنا من شتّى الأفكار المختلفة التي أخذناها من مصادرها الأصلية ومن معلّمين وأساتذة أفذاذ كانوا مخلصين لرسالة العلم والمعرفة وحضرنا في مختلف نوادي الثقافة ودُورها تلك التي كانت مثل خلايا النّحل تعُجّ بالروّاد والأفكار ومختلف الفنون مثل دار الثقافة اِبن خلدون ودار الثقافة اِبن رشيق والنادي الثقافي أبو القاسم الشّابي والنادي الثقافي الطاهر الحداد وجمعية قدماء الصادقية وغيرها… حيث أنصتنا إلى عديد الأدباء والشعراء والمثقفين تونسيين وعرب وغيرهم… ثمّ تراجعت الحياة الثقافية عامة في أواخر القرن العشرين حتى تدهورت خلال هذه السّنوات من “الربيع العربي” فأمست إلى السّطحية وإلى ضيق الأفق المعرفي تميل… وَاحسرتاه…! فقد صار حالنا كقول الشّاعر القديم:
رُبَّ يومٍ بكيتُ منهُ فلمّا * صرتُ في غيره بكيتُ عليه
ما أجملُ من الهوى الأوّل إلا الهوى الثّاني
فقد نشأ عن الهوى الأول وظل ملازما له دائما فسكن معه مهجتي بلا بغضاء ولا منافسة ولا حسد بل تعاشرا بالألفة والمعروف إلى اليوم حتى لكأن الواحد منهما أصبح توأما للآخر أو كجذع الشّجرة الذي تفرّع إلى فرعين.
عندما كنت أتردّد على مكتبة العطارين كنتُ أمرّ أمام مقهى الأندلس القريب من جامع الزيتونة أيضا وهو مقهى من الطراز العتيق بطاولاته الرخامية الصقيلة وبكراسيه الخشبية الظريفة والمتناسقة مع اللوح الجميل المُخرّم الذي يغطي الجدران وصاحب هذا المقهى حريص عليه كحرصه على أناقة لباسه التونسي بالجبّة والبرنس والشاشية وكحرصه على ضبط وقته وهو يُخرج ساعةَ جيبه ذات السلسلة الذهبية من حين إلى آخر فكنت أراه جالسا على يمين مدخل المقهى وهو المركز الاِستراتيجي الذي يراقب منه الداخل والخارج ويرى منه جمبع الطاولات ومن حولها وما عليها فكنت أتهيب الدخول إليه فالمقهى كان يُعتبر في تربيتي مكانا للكبار فقط وهو فضاء مريب لأن الجلوس فيه مضيعة للوقت في الكلام ولعب الورق والقمار… غير أنّي علمتُ أن الشّاعر أبا القاسم الشابي كان يجلس مع أصدقائه في هذا المقهى فوجدت الذريعة لنفسي وتقدّمت إلى إحدى الطاولات وطلبت فنجان شكلاطة بالحليب كما فعل الذي كان جالسا بجانب الطاولة المجاورة وظل ذلك طلبي دائما.
من الهوى الأول إل الهوى الثاني
يومها كان اللقاء الأول مع الهوى الثاني… هوى المقاهي.
في مقهى الأندلس كنت أجلس أقرأ الجرائد والمجلات وبعض الصفحات من الكتب التي كنت أشتريها فأجلس في ناحية على عجل أكتشف سطورها بنهم على رشفات فنجان الشكلاطة بالحليب الذي من النادر جدا أن تجد نكهة مذاقه في المقاهي الأخرى.
في مقهى الأندلس جلست مع كثير من أصدقائي الأدباء والشعراء مثل خالد النجار وعبد الحميد خريف ومصطفى المدائني ومختار اللغماني ومحمد الطاهر الضيفاوي والحبيب السالمي ومحمد أحمد القابسي ومحمد البدوي وعزوز الجملي وغيرهم من زملاء كلية الآداب بتونس فقد كان ذلك المقهى ملتقى لرواد المكتبة الوطنية وقتذاك من طلبة وأساتذة وباحثين…
ومن رواد المقهى المواظبين الذين لا يجب أن أنسى ذِكرَهم “أستاذ التعاسة” هكذا عُرف بين الأدباء فقد كان يجلس بينهم من مقهى إلى مقهى ومن نادي إلى نادي، هو رجلٌ لطيفٌ فصيحُ العبارة يلبس السّواد دائما ويخُوض في المسائل الفكرية والأدبية والسياسية ويُفيد ببعض التفاصيل أحيانا ومن خلال سياق أحاديثه يعلمك أنه اِنقطع عن تعليمه العالي بسبب دخوله السّجن ضمن بعض المحاكمات السياسية ثم بعدما غادره سافر إلى القاهرة وبغداد وبيروت فتعرف على كثير من الأدباء والشعراء والصحافيين والسياسيين، وهم أصدقاؤه جميعا وقد اِستنبط – حسب زعمه – نظرية خاصة به من خلال مسيرته وقراءاته أطلق عليها نظرية التعاسة وتقوم على أساس العيش الهامشي إن “أستاذ التعاسة” شخصية عرفها أغلب أدباء سنوات السّبعين والثمانين في تونس وكانوا يلاطفونه ويحسنون إليه بما يتيسّر لهم غير أن بعض الشعراء الشباب الذين وفدوا على العاصمة وقتذاك اِنبهروا به فجعلوه مثالا لسلوكهم حتى جنحوا إلى الحياة الهامشية فظلوا مع الأسف على هامش الحركة الأدبية ولم يعمّقوا تجربتهم الإبداعية ثمّ حَدث ما لم يخطر على بال أحد فقد تحوّل المقهى في منتصف سنوات الثمانين إلى مقرّ بنك وقد اِنبرى حينذاك عديد الأدباء والصحفيين داعين للمحافظة على المقهى لأنه يرمز إلى الذاكرة الثقافية فهو مَعلم من معالمها النابضة ولكن خاب المسعى فقد اِنتصر الدّينار والدولار على الأدب والأشعار وقد تحولت أيضا الكُتبيّة التي كانت بجانب مقهى الأندلس إلى دكان بضائع سياحية ولم يَبق من هاتيك المعالم إلا مطعم المهداوي المختصّ في الأكلات التونسية التي كان يطهيها على الفحم وفي قُدور من نحاس كبيرة.
منذ سنوات تبدّل كل شيء… فلا مكتبة عطارين ولا مقهى ولا شذى هاتيك العطور التي تنفحك وردا وياسمينا ومسكا وعنبرا وأنت تمرّ أمام الدكاكين الصغيرة المنضّدةِ قواريرُها بحُسن تنسيق وكثيرا ما يدعُوك أربابُها بلطف وظرافة إلى طيبهم و قَرنفلهم بل ويرشّونك بماء الورد والزّهر أحيانا…


شارك رأيك